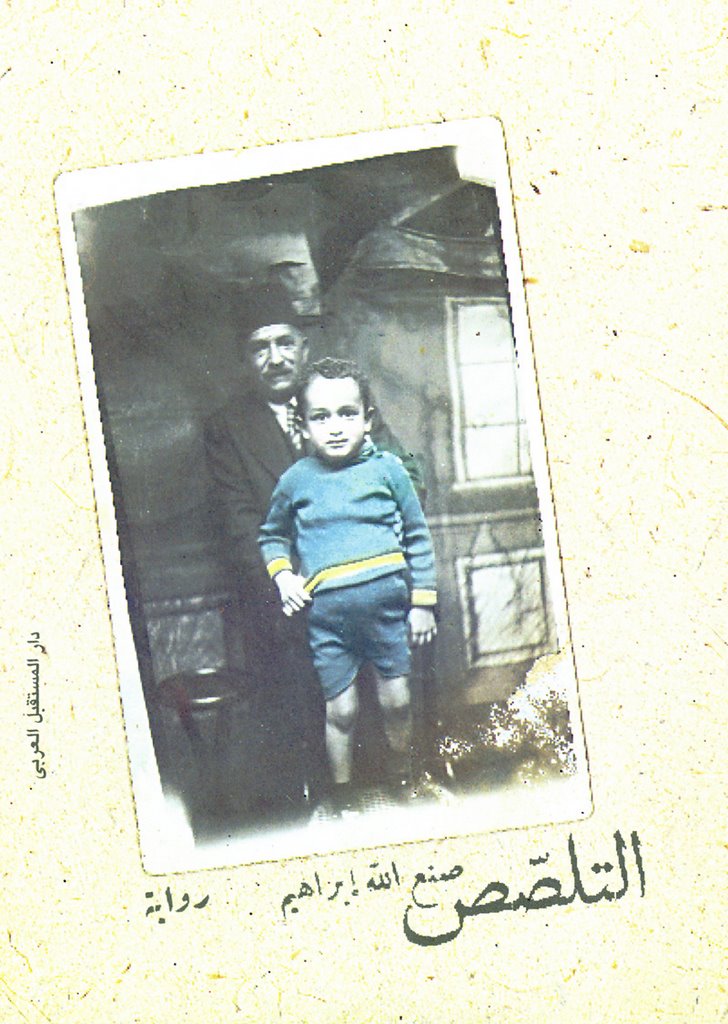فيصل .... تحرير: أيام الديسك والميكروباص – حمدي عبد الرحيم – مكتبة مدبولي
يضم الكتاب يوميات المؤلف في النصف الأول من عام 2007، إذ يحكي عن عمله في ديسك ثلاث جرائد ( نهضة مصر، العالم اليوم، الكرامة) وذهابه وعودته من عمله مستقلاً ميكروباص خط فيصل تحرير. يبدأ الكتاب بتقديم، ثم تأريخ لصعود – دون هبوط- الميكروباص : عندما رفعت الحكومة يدها عن قطاع النقل ، تاركة خدمات النقل تنهار ليملأ القطاع الخاص -ممثلاً في الميكروباص - الفراغ الناتج . منذ ذلك اليوم الذي وقف فيه ميكروباص وحيد في ميدان التحرير ، يجمع في خجل – تلاشى سريعاً- الركاب، انتهاء بقضائه النهائي على المنافسين. يقدم المؤلف بعدها قائمة بالمصطلحات التي سيستخدمها لاحقاً في الكتاب، إذ يقدم قوائم بأنواع السائقين والركاب والديسكاوية. وهي مصطلحات ساخرة ، لكنها مضبوطة يكفي ذكرها لاحقًا لترى أمامك الشخص المذكور متجسدًا بكل صفاته. فمن السائق السني – بشرائط أبو إسحق واللحية والجلباب الأبيض- إلى المتطرف – الذي لا ترغب أبداً في الدخول في مشاجرة معه- إلى الدجاجي – وهو ليس جباناً كما قد يتبادر إلى الذهن، بل كالدجاج يجلب الخراء بقدميه- مروراً بالمعاشي والروش....إلخ، والركاب إما ذاهلون أو عاديون أو ثقلاء...إلخ.
يشرع المؤلف بعدها في قص يومياته الموزعة بين الديسك والميكروباص. الديسك " هو المطبخ الصحفي حيث يجري إعداد المواد الصحفية للنشر". يكشف المؤلف عن خبايا هذا المطبخ الصحفي، الذي أصبح العمل فيه يتجاوز إصلاح خطأ إملائي أو نحوي هنا وهناك، أو إعداد مقدمة موضوع، ليصل – في أحيان كثيرة- لإعادة بناء لركاكة ورثاثة مذهلة، بل وحتى فك رموز ما يكشف عن عجز الكاتب عن التعبير المنطقي عن الأفكار وما قد يقارب حدود الثغاء أو سلطة الكلمات. نقرأ عمن يعتقد أن العزوف معناه العزم، وأن بعض تعني بعد، ومن يتحدث عن شروط الالتحاق ب"السيرك" الدبلوماسي، ومن كتبت " كان المتهم يبكي فقال له الضابط هذا وتعود وقائع الجريمة إلى وكان فريق من الأمن بقيادة اللواء قد حاصر المتهم"....إلخ.
أما يوميات الميكروباص، فهي الجزء الأكثر جذباً والأكثر مسخرة! ستتذكر ربما تاكسي الخميسي ، حيث الكتاب محاولة – بورجوازية من كرسي الراكب، لكنها حقيقية - لفهم ذلك الكائن – سائق التاكسي- والاستماع إليه وتقديم حكايات عديدة عنه ، وبلسانه، في كتاب سهل وجذاب. أما كتاب عبد الرحيم ، فهو وصف لمن عايشهم المؤلف من ركاب وسائقين من فيصل إلى التحرير وبالعكس. فردية وسيلة مواصلات كالتاكسي، يقابلها الميكروباص كفضاء اجتماعي يتقاسمه مجموعة من البشر لفترة من الوقت. نرى في اليوميات أمثلة على الصراع على المجال العام، واختراق المجال الخاص، وتنوع القيم الحاكمة والمرجعيات التي يلجأ إليها الأشخاص لفض الخلاف أو لحسمه، والاختلافات في طرق التعامل والطباع بين الأشخاص – وفي أحيان أخرى بين الطبقات أو الأجيال- . نرى طيبة وبلطجة، وقاحة وتهذيباً، تضامنًا وسفالة.
يقدم الكتاب صورة لمصر من الميكروباص في 2007، مستخدمًا حكايات جذابة ومسلية ومضحكة أحياناً، وباعثة على التأمل أحياناً أخرى، يعجز أي أسلوب أدبي غير اليوميات عن تقديمها. وهكذا نقابل مشاجرات الركاب مع السائق الأرعن، أو حل الركاب لمشاكل زوجين متخاصمين، أو مشاركتهم في عزاء أو تطييب خاطر. نقابل وصلات السباب بين السائق والتباع، وصلات الرقص والغناء الخارج ، والكلام الفضائحي عن أدق التفاصيل الشخصية. نستمع إلى مناقشات سياسية ، وأخرى عن الكرة، وغيرها تبحث عن حل لمشكلة مصر. نتلصص أحيانًا على حوار شخصي.، وأحياناً نرسم صورة عن حياة راكب ، مكملين القدر القليل الذي وصلنا منها بينما يتحدث في هاتفه المحمول. نقابل من يتحدث بحكمة وليدة السنين، ومن رأسه في خواء الربع الخالي.
يقول المؤلف أن الجامع بين اختياره للديسك والميكروباص ليجعلهما محور يومياته هو العشوائية التي طبعتهما بطبعها، لكنني أرى أن الجامع الرئيسي بينهما هو أنهما يشغلان الجزء الأكبر من حياة المؤلف نفسه ، حياة مصري يناضل ليعيش في مصر 2007. يمضي المؤلف معظم ساعات يومه في عمل مرهق لا يحتمل – ككثير من المصريين- مع الديسك ومساخره و "مجعزاته" ، أو معذبًا بقراءة أخبار وتحقيقات مروعة عن مصر والفساد والتلوث والديكتاتورية – تدور الأحداث في مطلع 2007 ، حيث تم تعديل الدستور ليصبح في إمكان السلطات التعامل مع أي مواطن كإرهابي بلا حقوق- والبحث عن أمل حيث لا نقطة نور تبدو في الأفق، أو – ككثير من المصريين أيضًا- معذبًا في رحلة الذهاب إلى ذلك العمل والعودة منه. لكنه يتعزى بقراءة كتاب، أو بلقاء صديق، أو بانتقام صغير يدبره لمسؤول حكومي منافق، أوبموقف يثبت له أن "الدنيا لسه بخير"، أوبابتسامة طفل نائم في حضن والده.
وبالمثل، كان كتاب حمدي أحد عوامل التعزية.....على الأقل بالنسبة لي.